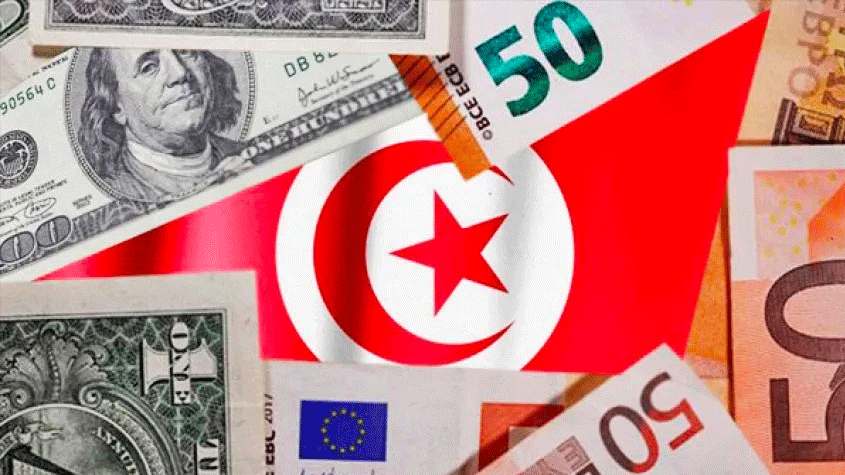عجزت كل القراءات السوسيولوجية التقليدية عن فهم التحولات الاجتماعية التي شهدتها تونس على امتداد العقد الأخير ما بعد الثورة ولم تنتج الجامعة التونسية ـ مثلا ـ ما يمكن اعتباره مرجعا لفهم هذه التحولات التي ضربت في كل المضارب واعادت انتاج كل القيم بما في ذلك القيم الرمزية والتي أصبحت ـ بدورها ـ مشتبكة نسقيا بالقيم التقليدية فلم تعد قيمة الحرية ـ مثلا ـ منفصلة عن قيم التربية والتعليم بحيث لا يمكن الحديث عن تعليم حداثي ومتطور دون ان تكون الحرية عنوانا من عناوينه… وقس على ذلك عمق التشابك… وهو ـ هنا ـ تشابك بديهي أو لنقل تشابك الضرورة بين قيم الديمقراطية وقيم المواطنة وهي ـ بدورها ـ قيم مرتبطة بكل ما يمكن ان يحدث من تحولات داخل المجتمع الواحد وبردود أفعال هذا المجتمع ومزاجات أفراده وبكل محاولات التغيير وهي بذلك «المحرك» الذي نقيس به «حياة» هذه المجتمعات التي نقول عنها في التوصيفات الدارجة بانها مجتمعات «حيّة» أي تلك «التي لا تبيت أبدا على مسلّمة» ـ كما يقول الراسخون ـ ولا تطمئن أبدا لما هي عليه وهي تبحث باستمرار عن الافضل والأكثر حيوية والأكثر رفاهية وعن كل ما يُديم سلامتها وكل ما يُثبّتُ استقرارها… وهي «مجتمعات حيّة» كونها لا تخشى الصراخ بصوت عالٍ ولا تخجل من الاحتجاج السلمي في الشوارع ولا ترفض التعدّد والاختلاف… وهي مجتمعات حيّة كونها لا تقبل الارتداد أو التنازل عن الافكار الكبرى وإن ظهر عليها التخاذل أو الاحباط فانها تتعافى بسرعة من أجل استرجاع حيويتها بما أنها مرتبطة ارتباطا كاملا أو هي مفتوحة انفتاحا كاملا على العالم وعلى الافكار وعلى السياسات عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي أنهت الجغرافيا وقلّصتها وفسحت المجال شاسعا أمام الشعوب الحرّة حتى تكتب تاريخها الخاص بها… وتاريخ الشعوب الحرّة إنما يتكثف في مدى قدرتها على انتاج فكرة «الخلاص الجماعي» أي ذاك الخلاص الذي يشترك في انتاجه طرفان أساسيان وهما «الدولة والمجتمع»… الدولة بما هي سياسات ومؤسسات والمجتمع كقوى مدنية حيّة ومنتجة تعتبر نفسها شريك بناء في الدولة ومؤسساتها بما يردم تلك الهوّة السحيقة بين «الدولة والمجتمع» وهما في الواقع طرفان مشتبكان ـ بالضرورة ـ ولا معنى لوجود أحدهما دون الآخر… فهل ثمّة «دولة» دون مجتمع…؟ على أن يكون للدولة ـ بطبيعة الحال ـ «عقل» لادارة شؤون المجتمع وان يكون لهذا المجتمع ـ أيضا ـ «عقل» للقبول بالسياسات والافكار التي ينتجها «عقل الدولة» وهنا ثمّة علاقة تعاقدية تنظم هذا البناء المتكون من «الدولة والمجتمع» وترتب حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر ونحن نتحدث عن «العقد الاجتماعي» والذي ينظم حياة الافراد داخل المجتمع ذاته وأيضا في علاقة بالسلطة وبالدولة ويحمي كل الحقوق الفردية من حريات وعدالة اجتماعية وكل ما جاورها من قيم انسانية تلتزم الدولة بصونها وبحمايتها بكل الطرق المُتاحة والمشروعة…
وتاريخ الشعوب يؤكد بان كل الثورات والانتفاضات التي عرفتها الانسانية إنما انفجرت بسبب اخلال أحد الطرفين (الدولة ومؤسساتها أو المجتمع وأفراده) بمواثيق والتزامات العقد الاجتماعي كأن تتحول الدولة الى دولة مستبّدة وغير عادلة أو أن يتحول المجتمع الى مجتمع لصوصية وجريمة وان تتحوّل أحزابه وجمعياته ـ مثلا ـ الى معاول هدم وَعَمَالَة تهدّد سلامة الدولة من الداخل بحيث يصبح ولاؤها للقوى الخارجية أكبر من ولائها لأوطانها… وفي مثل هذه الحال يسقط كل تعاقد ويخرج الطرفان من دائرة «العقد الاجتماعي» والتزاماته وتكبر بينهما الهوّة خاصة اذا ما أطلقت الدولة ما تحتكره من «قوّة صلبة شرعية» لتدافع عن وجودها وعن استقرار مؤسساتها وسلامة مواطنيها تجاه ما تسميه اختراقا لأمنها أو لسيادتها عبر «عَمَالات» فردية أو جمعياتية أو حزبية…
كيف نفهم ما يحدث اليوم في تونس من «تدافع» بين الدولة وبعض القطاعات الحيوية وهي قطاعات وازنة أيضا على غرار المحاماة والاعلام وهو «تدافع» تغذيه شخصيات سياسية اخوانية تتحرك بوجوه مكشوفة وتلبس جبّة المحاماة وهي بصدد تحريك معاول الفتنة حتى لا تهدأ أبدا… نعيد السؤال مرّة أخرى… كيف نفهم ما يحدث من «افتعالات» وصلت الى هذا الحدّ من التدافع بين المحاماة والأمن؟!
أولا لا بد من التأكيد ـ هنا ـ على مسألة على غاية من الأهمية وهي انسحاب أو «موت الاحزاب» والمنظمات التي كانت تلعب دور الوسيط بين السلطة والمجتمع وكانت تتكلم باسم التونسيين أو فئة منهم أو باسم القطاعية… اليوم وبعد «موت هذه الاحزاب» أصبحت «الدولة» في مواجهة مباشرة مع الغضب الاجتماعي أو الغضب القطاعي وهو ما يحصل اليوم مع قطاع المحاماة الذي يتحرك باسناد من هياكله المهنية فحسب أي دون حزام سياسي حزبي كما كان يحدث سابقا (إذا ما استثنينا المعاول الاخوانية التي تتحرك بجبّة المحاماة…) وبالتالي فإنه على الدولة ـ هنا ـ وهي تواجه قطاع المحاماة بشكل مباشر ودون وسائط أو أحزمة حزبية أن تفتح الحوار مع هذا القطاع وأن تنصت اليه وأن لا تعتبر غضبه عملا عدوانيا ضدّها وهو ما عبّر عنه عميد المحامين بوضوح وما تلقاه رئيس الجمهورية أيضا بتأكيده ـ أول أمس ـ «بأن الدولة لا مشكلة لها مع قطاع المحاماة» وقد أكد على التاريخ النضالي للمهنة…
ولو تأملنا هذا «التدافع» بموضوعية فإنّنا أمام حركة احتجاجية على خلفية واقعتين لا علاقة لهما جوهريا بقطاع المحاماة… الواقعة الأولى وتتمثل في تصريح اعلامي لناشطة اعلامية (وهي محامية غير مباشرة) اعتبر مسيئا لتونس وهذا التصريح لم يصدر عنها أثناء مرافعة ولا داخل محكمة بل من على منبر تلفزيوني و«بصفتها التلفزيونية» وايقافها جاء بسبب ما اعتبر اساءة وبالتالي فإن تحرك قطاع المحاماة برّمته من أجل «حادثة تلفزيونية» لم يكن في محلّه بل تم دفعه إلى مواجهة مع السلطة كان في غنى عنها… الواقعة الثانية وتتمثل في اعتداء محام على عوني أمن وهي موثقة بالصوت والصورة وقد تم ايقافه تطبيقا للقانون ووفق الاجراءات المعمول بها… لكن كيف تم تطبيق القانون وهل كانت ثمّة تجاوزات أمنية في حادثة الايقاف فتلك مسألة أخرى موكولة للتحقيقات…
وبناء عليه فإن الذهاب في اضراب عام أول ثم اضراب عام ثانٍ في قطاع المحاماة إنما فيه من المغالاة ما يدعو الى طرح عديد الاسئلة في علاقة بتلك الوجوه المكشوفة التي دفعت الى التصعيد وورطت القطاع في «حراك» أكبر من «الواقعتين» المشار اليهما وبالتالي فإننا ندعو الى التجاوب مع نداء عميد المحامين الذي دعا رئيس الجمهورية الى الانصات اليهم والى مشاغلهم ففي ذلك دعوة ضمنية للتهدئة ولانهاء هذا النزاع المفتعل ونتوقع ان يستقبل الرئيس خلال الساعات القادمة عميد المحامين بما يقطع الطريق أمام المستفيدين من الازمة…!
هذه في الظاهر معركة بين المحاماة والسلطة… وهي في الواقع وفي العمق معركة بالوكالة بين جبهة الخلاص تحت القيادة الاخوانية والسلطة القائمة…
والوجوه كما أشرنا مكشوفة وبصدد الدفع نحو التصعيد لتوسيع دائرة الاحتقان ولتأزيم العلاقة بين قوات الأمن والمحاماة والأهداف كما هو واضح سياسية في علاقة بأوهام العودة التي لم يبرأ منها «أخوان تونس»…!
متشائلون إلى حين..!
لقد كانت سنة 2024 في تونس سنة اطلاق النوايا الكبرى… سنة التأسيس والتأصيل للدولة ومؤ…