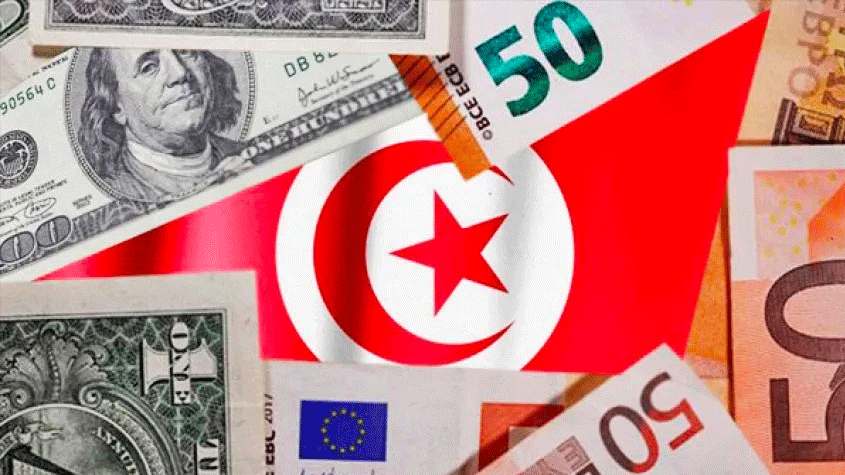علينا الإقرار اليوم ان تونس تحولت الى مخبر سوسيولوجي كبير تتلاطم فيه القضايا والوقائع بشكل يدعو الى الحيرة ويحفّز على التفكير والتدبر.
ونقطتا الارتكاز في هذا المخبر الكبير هما قطعا الشرطة والقضاء ولسائل ان يسأل كيف ذلك والاجابة بسيطة وواضحة ولا لبس فيها وهي ان التحولات العميقة في مجتمعنا يمكن تتبعها عبر القضايا الاجرامية التي ترصدها مراكز الامن ثم يتم النظر فيها بعد ذلك قضائيا.
ولاشك ان من يتابع في السنوات الأخيرة الفعل الاجرامي الذي يتم الإعلان عنه في المنابر الإعلامية عبر بلاغات الشرطة او تدخلات بعض الناطقين باسم المحاكم يرصد اهوالا تشيب لها الولدان فالتطور السريع للجريمة وإمعان مرتكبيها في الوحشية امر يدعو الى الذهول.
فمعلوم ان الجريمة افراز للمجتمع والاسرة وهي نتاج تنشئة اجتماعية في المقام الأول وبيئة ومناخات عامة تحرّض بشكل مباشر او غير مباشر على مثل هذه الممارسات. فالظروف الاقتصادية الصعبة ذات صلة مباشرة بتراجع المعايير وبالتالي بالتدهور القيمي وما ينجر عنه من انحرافات في السلوك تقود حتما الى الجريمة بكل انماطها.
وهذه الديباجة نعتبرها ضرورية للخوض في مسألة بالغة الخطورة بتنا نرصدها مؤخرا من خلال البلاغات والوقائع التي نتابع تفاصيلها. فالملاحظ ان هناك جرائم كثيرة كان مرتكبوها من الأطفال وهناك عصابات متكونة من أطفال لم يتجاوزوا عمر 12 سنة مثلا تنشط في مجال المخدرات والسرقة وهناك حتى من ارتكب جرائم قتل. واصبح من العادي ان نسمع بتفاصيل جريمة كل الضالعين فيها من الأطفال او هم الفاعلون المنفذون وخلف الستار هناك عصابات تتاجر بهم وتوظفهم مستفيدة من عدم ملاحقتهم قانونيا باعتبارهم من القصّر وهذا مربط الفرس.
فمعلوم ان الجريمة المنظّمة لها ملامح عامة من بينها البحث عن الثغرات التي لا تؤدي الى الملاحقة القانونية او التي يمكن الخروج منها بأقل «تكلفة» قانونية أو جزائية. وهذا ما يحدث بالضبط في الجرائم التي يكون مرتكبوها من الأطفال فغالبا ما يعودون الى بيوتهم «فرحين مسرورين» رغم خطورة الجرم الذي ارتكبوه. وفي حالات كثيرة يكون لبعض الاولياء الضلع الأكبر في مثل هذا السلوك.
فتجارة المخدرات مثلا التي أصبحت من الآفات الخطيرة التي تهدد المجتمع التونسي ويقف خلفها أباطرة يحركون الخيوط من خلف الستار تم اكتشاف عدد كبير من الأطفال الذين يقومون بالترويج فضلا عن الاستهلاك خاصة في الوسط المدرسي.
ويبدو ان خيوط العنكبوت لا تقتصر على المتاجرة في السموم فالأمر يشمل كذلك السرقة و«النشل» او البراكاجات سواء في الشارع او وسائل الاعلام الى جانب العنف في الفضاء العام وصولا طبعا الى القتل.
وإذا كان هذا التشخيص فإنه بالتأكيد معلوم للجميع لكن إيجاد الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة بشكل عاجل وناجع اصبح أكثر من حتمي.
والحلول ينبغي ان تكون متعددة تتضافر فيها جميع الجهود وأولها الإحاطة والتنشئة السليمة وهي مسؤولية الأسر والتي تراجع دورها بشكل كبير وبعضها مستقيل من مهمة التربية ويقتصر دوره على الرعاية المادية فقط. اما بالنسبة الى المدرسة التي أصبحت طاردة لأبنائها وفضاء في بعض الأحيان يشجع على العنف فلابد ان تستعيد دورها التربوي والحاضن لأبنائها. وكذلك الشأن بالنسبة الى المؤسسات الثقافية التي أصبحت خاوية على عروشها ولابد من إعادة الوهج اليها لتستقطب الأطفال وتؤطر مواهبهم الفنية بدل ان يتركوا فريسة للانحراف.
لكن مع كل هذا لابد الآن من سنّ تشريعات تتسق مع التحولات الجديدة ومع انتشار الجريمة في صفوف الأطفال للقضاء على ظاهرة استغلالهم كأدوات إجرامية فلابد من إيجاد عقوبات تتماشى مع سنّهم ومع ظروفهم تفاديا للإفلات من العقاب ولقطع دابر الجريمة في صفوفهم.
وهذه مسؤولية البرلمان الذي من المهم ان ينكبّ على إيجاد التشريعات اللازمة للظواهر الخطيرة المستجدة التي لابد ان تجابه بقوة القانون.
«ضرورة اختصار كل ما هو إجرائي لإنجاز المشاريع المعطّلة» لا مجال للتّراخي..تونس لم تعد تحتمل الإنتظار..
إلى متى يتواصل هذا التراخي بشأن المشاريع الكبرى التي من شأنها تغيير الكثير من حياة التونسي…